عند بزوغ فجر الألفية الثالثة خطا علم التقنية الحيوية خطوات كبيرة للأمام بعد الإعلان عن رسم الأطلس الوراثي للإنسان، وهو المشروع الذي عُرف بمشروع الجينوم البشري. وانتشرت في معظم وسائل الإعلام موجة من الآمال العريضة تشير إلى أن إنجاز هذا المشروع الكبير يعني بداية الخلاص من أخطر الأمراض، بما في ذلك السرطان. لكن سرعان ما تبخرت هذه الآمال، بعد أن أيقن العلماء أن هذا الإنجاز لا يزيد عن فتح أحد الأبواب الرئيسة المغلقة المؤدية لفهم الأمراض وعلاجها، فما توصل إليه العلماء حتى الآن هو قراءة كتاب الحياة فقط، لكن فهمه واستيعابه والاستفادة القصوى من جميع معطياته، يحتاج إلى المزيد من البحث.
وإنجاز مشروع الجينوم البشري صاحبته مفاجآت كثيرة، من بينها أن عدد الجينات في الإنسان 34 ألفا فقط، وليس مائة ألف كما اعتقد العلماء لمدة طويلة، ولهذا برز سؤال مهم هو: كيف أمكن تكويننا بمثل هذا الإعجاز والتعقيد من خلال 34 ألف جين فقط.. علما بأن ذبابة الفاكهة تملك 13 ألفا من الجينات ونبات “الأرابيدوبسيس” يملك 25 ألف مورث فقط؟
وسارع العلماء بالبدء في مشروع البروتيوم للإجابة على هذا السؤال الصعب، الذي لخصه العالم الأمريكي “بريان شيت” فيما يلي: “إن ما نريد اكتشافه هو أن في أعماق كل فرد مائة تريليون خلية.. فما هو نوع كل بروتين تنتجه هذه الخلايا؟”. لذلك كان لا بد من ترتيب وجرد وتحليل البروتينات والجزيئات المرتبطة بها ذات الأدوار الجوهرية بالنسبة للكائنات الحية، بعد أن تأكد العلماء أنه لا يكفي معرفة الجين المسئول عن حفز الخلايا الحية لإنتاج أنواع بعينها من البروتينات، بل ينبغي معرفة حالة الخلايا أثناء الصحة أو المرض.
ويأمل العلماء أن يكون عام 2002م هو بداية الإنجازات التاريخية في مشروع “البروتيوم” البشري، الذي يجيب على هذه التساؤلات الحائرة؛ فالبروتيوم يحتوي على أسرار وتعقيدات تزيد عن الجينوم، وقد يحتاج الفهم الكامل لما تنتجه كل خلية من خلايا أجسامنا من بروتينات أثناء المراحل المختلفة لحياتها، والتي قد تزيد عن مليون نوع من البروتينات المختلفة إلى عشرات السنين، ولهذا فإن مهمة العلماء في هذا المشروع تتسم بالصعوبة الشديدة.. إنها مهمة عملاقة تزيد في صعوبتها عن مشروع الجينوم البشري، برغم التقدم العلمي والتقني الذي يتقدم للأمام بخطوات سريعة.
ما هو البروتيوم؟
ظهر مصطلح “البروتيوم” عام 1994م، وأدخله في دنيا العلم الباحث الأسترالي الشاب “مارك ويلكينز”. وجاءت هذه التسمية لتشير إلى الحصيلة الكلية للبروتينات المتواجدة في كل نوع من أنواع الخلايا الحية على حدة؛ فكل خلايا الكائن الحي المعين تحتوي الجينوم نفسه، لكن كلها (أو كلها تقريبا) تحتوي بروتيومات متباينة.
وإذا كان “الجينوم” Genome يعني جميع الجينات الكامنة في خلايا الجسم، فإن “البروتيوم” Proteome هو مجموع البروتينات التي تفرزها خلايا الجسم خلال المراحل المختلفة من حياتها. وإذا كان “الجينيوم” من التعقيد بحيث ينطوي على ملايين العمليات الكيميائية، فإن “البروتيوم” يحتوي على معلومات تزيد ألف مرة مما يحمله الجينيوم!
وللتعرف علي معنى “البروتيوم” علينا أن نتجول قليلا مع بعض المصطلحات العلمية؛ فمصطلح “بروتين” الشهير جاء من اسم أحد آلهة اليونان Protee، وكان قادرًا على اتخاذ آلاف الأشكال وأكثر الأشكال غرابة حتى يستطيع الهروب من مطارديه. وتتكون البروتينات من تسلسل مئات الجزيئات الصغرى والأحماض الأمينية التي يوجد منها عشرون نوعا مختلفا.
http://www.islamonline.net/Arabic/Science/2002/01/images/pic2.gif
وعملية بناء البروتين داخل الخلايا الحية تعتمد على المعلومات المحفوظة في الجينات الكامنة في الحمض النووي DNA (الحمض النووي الريبي منقوص الأوكسجين) الموجود في كل خلية حية. وعادة ما يتم نسخ هذه المعلومات في الحمض النووي RNA (الحمض النووي الريبي)، وهو عبارة عن جزيء شبيه بالحمض النووي DNA لكنه يتواجد بكثرة خارج النواة. ويعمل هذا الحمض بمثابة قالب لتجميع البروتينات بواسطة مختبر بيوكيميائي صغير يعرف بـ”الـريبوزوم”. ويقول العلماء بأن الجينات ترمز للبروتينات. ولتبسيط الصورة اعتبر العالم البريطاني “جون سميث” أن الحمض النووي DNA شريط ممغنط كشريط التسجيل، و”الريبوزوم” جهاز التسجيل، والبروتينات هي موسيقى الحياة.
في بداية الستينيات اكتشف رواد البيولوجيا الجزيئية أن جينا واحدا يقابل (ويطابق) بروتينا واحدا. وفي السبعينيات أعاد عالم البيولوجيا ومؤرخ العلوم “ميشال مورانج” تكوين مفهوم الجينات، وأثبت أن جينا واحدا يمكن أن يشكل عدة بروتينات بفعل انحراف آلية تُدعى “الانثناء التتابعي”. وتبعا لهذه الآلية تنتج الخلايا بروتينات مختلفة انطلاقا من متوالية الحمض النووي DNA نفسها. وهذه التغيرات البسيطة تكفي في غالب الأحيان إلى تغيير وظيفة البروتين كليا، وقد يقدر جين واحد على إنتاج نحو عشرين بروتينا مختلفة. ويقدر العلماء عدد أنواع البروتينات المنطلقة في الجسم فيما بين 500 ألف إلى مليون بروتين، لكن كل خلية من جسمنا لا تحتوي غير عشرة بالمائة من هذا المجموع؛ لأنه في لحظة معينة واستنادا إلى تخصصها لا تعبر الخلية إلا عن جزء من جيناتها. ونتيجة ذلك تحتوي كل خلية مجموعة متميزة من البروتينات، وهذا هو البروتيوم الخاص بها، ومعرفة كل نوع تعتبر ضرورية للتشخيص الدقيق للمرض.
وتكتسب البروتينات هذه الأهمية الكبيرة؛ لأنها الناتج النهائي لعمل الجينات، ولأنها تحكم تصرفات وأفعال الكائنات الحية من المهد إلى اللحد. وكل بروتين يحتاجه الجسم محفوظ كشفرة كيميائية في الحمض النووي DNA، ولأن هذه الجزيئات تؤدي الأدوار الضرورية لعمل الخلية الحية، ومنها: الإنزيمات (الخمائر) التي تسرع التفاعلات الكيميائية، والمستقبلات التي تخبر الخلايا عن حالة الوسط الخارجي، والأجسام المضادة التي تتعرف على الجسيمات الغريبة في الكائن الحي. وعندما يحدث المرض تكون البروتينات هي المسؤولة؛ لأنها تكون عاجزة عن حماية الخلية، ولأن ميكروبا أدى إلى اضطرابها. ولهذا فالبروتينات هي الهدف الرئيسي للأدوية. وإذا أراد العلماء إعطاء المريض جرعات دوائية ناجعة تصيب هدفا محددا بوضوح، فلن يكون هذا الهدف سوى أحد البروتينات أو عملية بيولوجية وثيقة الصلة بهذا البروتين.
وعلى سبيل المثال عندما يهاجم الفيروس الخلية فهو يعوق تخليق غالبية البروتينات. أما البروتينات التي تخلقت بعد الهجوم فيستعملها الفيروس في عملية التكاثر أو تستعملها الخلية حتى تكافحه. وهذه البروتينات هي أهداف محتملة للأدوية المضادة للفيروسات، ولهذا يعمل العلماء على ابتكار طرائق علمية للمقارنة بين حالتي البروتيوم قبل العدوى وبعدها، والحصول على معلومات دقيقة عن هذه البروتينات يؤدي للحصول على دواء جديد قادر على القضاء على هذه الفيروسات.
المصانع البروتيومية
شكل يظهر الاختلاف الكمي والنوعي للبروتينات المستخلصة من الخلايا الحية
وبناء على ما سبق ينبغي التصدي للبروتينات بعد فك رموز الجينوم، لكن طبيعة البروتينات نفسها تجعل هذه المهمة صعبة للغاية لتنوعها غير العادي. ولتحليل “بروتيوم” خلية بالطريقة الاعتيادية يجب أولا أن تفصل المكونات باستعمال تقنية معروفة باسم التفريد أو الاستشراد الكهربائيElectrophoreses ؛ أي انفصال جزيئات محلول بتأثير حقل مكهرب، وللتعرف عليها ينبغي اللجوء إلى مقياس طيفي للكتلة.
وكانت هذه الطريقة التقليدية المستعملة في المختبرات حتى اليوم، لتحليل البروتينات طويلة وشاقة إلي أن توصل “دنيس هوشتراسر” من المعهد السويسري للمعلوماتية البيولوجية في ربيع عام 1999م إلى ابتكار جهاز أسماه “الماسح الجزيئي” Molecular Scanner يستطيع أتمتة جميع المراحل. وبدمج هذا “الروبوت” بنحو مائة مقياس طيفي للكتلة من أحدث الأنواع أمكن التعرف على عشرات الآلاف من البروتينات في اليوم؛ أي أكثر بعشرة أضعاف مما كان متاحا من قبل. وقد جمع “كريج فينتر” 940 مليون دولار من أجل بناء “مصنع بروتيومي” قادر على تحليل مليون بروتين في اليوم لبناء أكبر قاعدة بينات بروتيومية بشرية ومقارنتها مع أي كائن حي آخر.
المبادرة البروتيومية
شكل يظهر صعوبة الشفرة الوراثية
والعالم “كريج فينتر” هو رئيس شركة Celera Genomics وهو صاحب أكبر عدد من براءات الاختراع في عالم البيولوجيا الجزيئية البشرية، وقد تصدر “فينتر” نشرات الإعلام المرئي والمسموع والصفحات الأولى في المجلات والجرائد في العالم بإعلانه الانتهاء من رسم متواليات الجينوم البشري قبل المختبرات الحكومية العالمية العاملة في مشروع الجينوم البشري Human Genome Project.
وتعد مبادرة “فينتر” بالانخراط في مغامرة جديدة لوصف عشرات الملايين من البروتينات التي ينتجها الجينوم البشري مغامرة كبرى بكل المقاييس؛ فقد تحقق له التفوق في سباق الجينوم عن طريق دعم شركات البيوتكنولوجيا، والاستثمار في صناعة الآلات الطبية والأتمتة، والتقدم في أجهزة الكمبيوتر وفي علوم المعلوماتية لجمع وتحليل المعطيات والبيانات، ولكن المغامرة الجديدة قد تكون محفوفة بالمخاطر!
وربما يغدو العالم “كريج فينتر” أشبه بـ”بيل جيتس” البيولوجيا، إذا توج نجاحه في هذا المجال ليصبح قطب عالم الجزيئات البشرية. لكن المشروعات الكبرى في هذا المجال المثير لا بد أن تجد لها منافسا قويا؛ فهناك عشرات الشركات الأخرى التي تنافس شركة Celera في السوق العملاقة للأبحاث البروتيومية، مثل: شركتي Hybrigenics وBioxtal الفرنسيتين، وتختص الأولى في وصف التفاعلات بين البروتينات في بروتيوم واحد. أما الثانية فتختص في تحليل البنية ثلاثية الأبعاد للبروتينات عن طريق التصوير الكريستالي بأشعة إكس. كما أطلقت خمسة من أكبر المختبرات الجامعية في نيويورك “المبادرة البروتيومية” وهي عبارة عن برنامج من خمس سنوات قيمته 150 مليون دولار مخصصة لدراسة بنية البروتينات. ويتنبأ المحللون باندماج الكثير من المؤسسات العلمية مع بعضها، وأن الاستثمار في مجال البيوتكنولوجي سيؤتي أكله هذا العام، حيث يوجد الآن عشرات العقاقير التي مرت بمراحلها النهائية في الاختبار، والعديد منها سيتم التصديق عليه من قبل إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية هذا العام، ومنها علاجات مضادة لأنواع من السرطانات.
البروتيوم ومستقبل صناعة الأدوية
البروتيوم الكامل لفطر الخميرة
وفي الأسبوع الماضي جاء أول الغيث في هذا المجال العلمي الواعد، عندما أعلن علماء كنديون في مستشفى “جبل سيناء” في “تورنتو” عن الانتهاء من تحديد بروتيوم فطر الخميرة التي تتكون من خلية واحدة. وهو أول بروتيوم لكائن حي يتم الانتهاء منه، لتسجل الخميرة سبقا في عالم البروتيوم. وبالرغم من أن تصنيف هذه البروتينات وترتيبها النهائي لم يكتمل بعد، فإن العلماء يعتبرون أن هذا العمل يمكن أن يغير طريقة تصميم الأدوية والعقاقير في المستقبل القريب.
فبالرغم من تكرار النداءات الطبية للحدّ من استخدام الأدوية الكيميائية والعودة للطبيعة؛ فنحن نتحرك نحو عالم سيكون فيه هجوم على استخدام الأدوية في الأمراض البدنية والسيكولوجية مثل الكآبة وفقدان الذاكرة والإدمان والقلق وغيرها. وهناك أسلوب جديد تماماً لصناعة الأدوية قد يمكن البشر أخيراً من التغلب على مشاكل الصحة وطول العمر، ويستخدم مصممو الأدوية الجديدة علوم البيوتكنولوجيا الطبية لمساعدتهم في هذا العمل. وسيؤدي التطور في علوم وتقنيات “البروتيوم” البشري إلى تغيير شكل الدواء خلال العقد الحالي والعقود التالية، وستتحول معظم الأدوية إلى أدوية مصنعة بالهندسة الوراثية أو التقنية الحيوية، وسيتم التركيز بشكل أساسي خلال هذا القرن على الطب الوقائي؛ أي منع المرض قبل وقوعه؛ وهو ما يؤدي لتغيير مفهوم التداوي والعلاج.
ولهذا فصناعة الدواء سوف تشهد تغيرا كبيرا خلال الأعوام القليلة القادمة، وسوف تتضاعف أسعار الدواء بعد تطبيق اتفاقية “الجات”، نتيجة لحقوق الملكية الفكرية واحتكار الشركات المكتشفة للدواء لإنتاجه. وسوف تشهد هذه الصناعة تحكم كبريات شركات الأدوية في العالم، التي تستثمر مليارات الدولارات لتطوير هذه التقنية الجديدة، وستقوم بتقديم هذه الأدوية للدول المستهلكة بالسعر الذي تريده، فأين نحن مما ستشهده صناعة الدواء خلال الأعوام القليلة المقبلة؟ وهل سنكتفي بمتابعة أخبار الإنجازات العلمية في هذا المجال، أم نشارك في صنع هذا المستقبل المشرق؟ سؤال مرير يبحث عن إجابة!
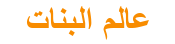 عالم البنات النسائي كل ما يخص المرأة العربية من ازياء وجمال والحياة الزوجية والمطبخ
عالم البنات النسائي كل ما يخص المرأة العربية من ازياء وجمال والحياة الزوجية والمطبخ