طنجة: مدينة مسكونة بالأسطورة، ومفعمة بالدهشة وروح الجمال، عند ضفافها تتكسر أمواج بحرين في عناق أزلي بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.
وعلى امتداد التاريخ كانت ملتقى للحضارات ومنتدى لتلاقح الافكار والتيارات، يقال إن من زارها، لا بد أن يعود إليها، ومن عاد إليها لا بد أن يسكن فيها، ويتآلف مع فضاءاتها وأهلها بسرعة، ويصعب عليه فراقها أو الانتقال منها، كثيرون من مبدعي العالم التجأوا إليها من أدباء ورسامين وموسيقيين، وطاب لهم المقام فيها.
ويصعب سرد كل الأسماء والوجوه الأدبية والفنية التي مرت من هنا، أو عاشت هنا، فكتبت نصا مسرحيا، أو رسمت لوحة، أو صورت فيلما، أو أبدعت قصة.. يكفي أن يكون من بين هؤلاء أوجين دولاكروا، وماتيس، ومارك توين، وتينسى ويليامز، وبول بولز، وصموئيل بيكيت، وجان جيني، وانطوني كوين، وسواهم.
من الناحية الجغرافية لطنجة موقع استراتيجي خاص، فهي تقع على خريطة المغرب، في أقصى نقطة من شماله، وبالتالي فهي واجهة المغرب ونافذته المشرعة على أوروبا، إذ لا تفصلها عنها سوى 14 كيلومتراً عبر البحر. ومن الناحية التاريخية، فلها سجل حافل، تزدحم صفحاته بالكثير من الوقائع والأحداث، منذ كانت مدينة دولية، تتعايش فيها الأجناس واللغات، إلى أن استرجعت حريتها واستقلالها.
ورغم تعاقب خطوات الغزاة والمغامرين فوق ترابها، بقيت طنجة، كما هي، محافظة على عطرها وسحرها، وعبقها القديم وانتمائها العربي والافريقي، غير آبهة بما خلفه الإنجليز والبرتغاليون والإسبان وراءهم من آثار ومعالم شاهدة على مرورهم بها لفترات من التاريخ، خاصة يوم كانت مدينة دولية، وعاشت تحت الحماية من سنة 1923 إلى سنة 1956.
من ناحية الطقس، تشتهر المدينة باعتدال مناخها، طيلة فصول السنة، ولا يضطرب مزاجها أحيانا، سوى أثناء هبوب ما يسمى بالرياح الشرقية، لا سيما في العطلة الصيفية الكبرى، التي تستقطب زوارا وسياحا، مواطنين وأجانب، من كل الفئات الاقتصادية والاجتماعية، يجيئون إليها بحثا عن الراحة والاستجمام على شاطئها الممتد بجانبها على مسافة ثلاثة كيلومترات والمشهور برماله الناعمة.
وأحيانا يفوق هذا الإقبال السياحي الطاقة الاستيعابية لفنادقها بمختلف تصنيفاتها، إذ تتحول المدينة طيلة اشهر يونيو ويوليو واغسطس، إلى معبر لاستقبال وتوديع أفراد الجالية المغربية المقيمين في أوروبا، الذين يحلو لهم التوقف او المبيت فيها لالتقاط الأنفاس، قبل مواصلة الرحلة على الطريق.
هي من اكبر محطات السفر والحل والترحال بامتياز، وليس ذلك بغريب عليها، فإن أحد أبنائها اشتهر برحلاته وجولاته حول الأقطار، تاركا وراءه للأجيال، مؤلفات تعكس مشاهداته لتلك الأصقاع البعيدة. إنه الرحالة العربي الشهير «ابن بطوطة»، الذي طاف الدنيا، وحين أعياه المسير، عاد ليدفن في تراب المدينة التي أنجبته. وتكريما له، فإن اسمه يتردد اليوم مئات المرات في ردهات مطار طنجة، الذي يحمل اسمه، ليكون أول من يستقبل القادمين إليها من مختلف أنحاء الكرة الأرضية.
لعل فندق «المنزه» التاريخي ذا الطراز المعماري المستوحى من الهندسة الأندلسية، أشهر فنادق طنجة، وهو من فئة خمس نجوم، وقد أنشئ سنة 1930 ويعتبر من أقدم المنشآت السياحية في المدينة، ويتميز بموقعه وسط المدينة، حيث الحركة التجارية والرواج الاقتصادي على أشدهما.
والآن، وقد بلغ من العمر حوالي 75 سنة، استقبل خلالها عددا من مشاهير العالم ونجومه في السياسة والسينما والأدب، فإن الزيارة السياحية إلى طنجة، لا يمكن أن تكتمل بدون التردد عليه.
ويقول سكان المدينة ان هناك فندقا آخر أكثر عراقة وقدما، وهو من بيوت الضيافة الأولى، إذ يعود تاريخ بنائه على مقربة من الميناء، إلى سنة 1870. وتتيح الإطلالة من شرفاته، أخذ نظرة بانورامية شاملة على مضيق جبل طارق، حيث تمخر السفن عباب البحر، غادية رائحة، كل يوم، محملة بالمسافرين القادمين من أوروبا، او الذاهبين اليها، لكن الصورة في الليل تكون أحلى، حين تتلألأ الأضواء، مثل عقد من ألماس، يتراقص فوق صفحة الماء.
كما ان التبضع في أسواقها الشعبية أو مراكزها التجارية الحديثة المزدحمة بالسلع والبضائع، من كل صنف ولون، فرصة للالتقاء بالسكان، والتعرف على ثقافتهم وانفتاحهم وأسلوب عيشهم وأذواقهم، وترحيبهم بكل وافد على مدينتهم.
مقهى «الحافة»، مكان فريد في نوعه، ويكتسب شهرته من موقعه الجميل على منحدر صخري، وينفرد بسطيحته الصغيرة، وواجهته البسيطة، وبكؤوس الشاي بالنعناع، ذي النكهة الخاصة.
واجتذب، على مر السنين منذ إنشائه سنة 1920، أناسا من كافة انحاء العالم، جلسوا فوق مقاعده، وأطلقوا العنان لنظراتهم تسبح بعيدا في شساعة هذا الكون، والتأمل في ملكوت الله. ومن الذين يحتفظون بذكريات عن مقهى الحافة، أفراد مجموعة «البيتلز» الموسيقية الإنجليزية أيام مجدها، والممثل السينمائي شين كونوري، المعروف بتقمصه لشخصية جيمس بوند.
ومن المواقع الجديرة أيضا بالزيارة «مغارة هرقل»، التي تحكى الأسطورة أن مزاج هرقل، كان متعكرا، حين ضرب الأرض بقوته، فانشطرت إلى نصفين، هما القارة الافريقية والقارة الأوروبية. ويشكل الدخول إلى المغارة عالما من الغموض والسحر والافتتان.
إلا أن أطرف وأغرب مكان في مدينة طنجة، هو سور (المعكازين) أي المعاكيز (الكسالى)، الذي يتجمع فيه السكان والزوار، أو يجلسون متناثرين في ساحته للدردشة، أو للتطلع إلى الضفة الأخرى، وراء البحر، حيث تتراءى اسبانيا من بعيد، إذا كان الجو صحوا. فسور الكسالى يمثل اقصى درجات الغواية للتفكير في الهجرة الى الفردوس الاوروبي.
وثمة منظاران بلون أزرق، منتصبان فوق الساحة لتقريب الرؤية أكثر بصفة أدق، مقابل دريهمات معدودة. وفي نفس الساحة يرقد مدفع قديم ما زال ماثلا للعيان، شاهدا على مرحلة تاريخية، كان له فيها دور الدفاع عن المدينة أيام الحروب. وهناك من يحرص على التقاط صورة للذكرى على أيدي مصورين متجولين، يكسبون رزقهم، بعرق أكتافهم، في ساحة تحمل اسم «المعاكيز» أي الخاملين. ويقال ان السبب في هذه التسمية يعود إلى تاريخ قديم، أيام القوافل التجارية، كان فيه التجار الناشطون ينزلون إلى السوق للبيع والشراء، بينما يجلس الخاملون منهم تحت ظلال الأشجار، للاستراحة من تعب الرحلة، فيستغرقهم النوم، ولا يقومون بالمهمة التي قطعوا المسافات من أجلها.
وإذا كانت القوة السياحية الضاربة لطنجة تكمن في جماليتها، فإن السكان لا يخفون تذمرهم مما لحقها في السنوات الأخيرة من خدش لمشهدها العمراني العام، من خلال البناء العشوائي الذي ينمو في جنباتها مثل نبات الفطر، إضافة إلى عمارات سكنية حديثة تحل محل الحدائق الخضراء، فيما يشبه هجوما كاسحا بالاسمنت المسلح على كل شبر فيها لاستثماره عقاريا. غير أن هناك جهودا مكثفة مبذولة، على المستوى الرسمي، من أجل الحفاظ على صورتها وتحسين بنيتها التحتية، واستغلال كل مؤهلات المدينة وروافدها الطبيعية والتاريخية، لتصبح نموذجا يحتذى به في الترويج التجاري والنهوض السياحي والثقافي والفني.
a;vh gbwyhx >>>>>
شكرا للاصغـــــــــــاء ………..
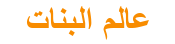 عالم البنات النسائي كل ما يخص المرأة العربية من ازياء وجمال والحياة الزوجية والمطبخ
عالم البنات النسائي كل ما يخص المرأة العربية من ازياء وجمال والحياة الزوجية والمطبخ